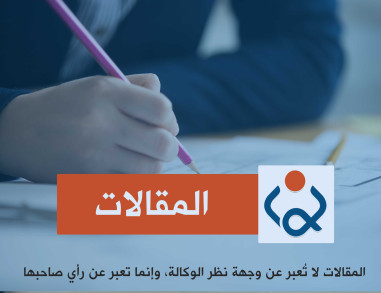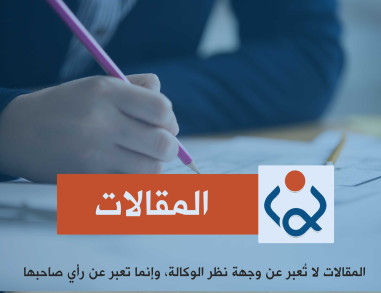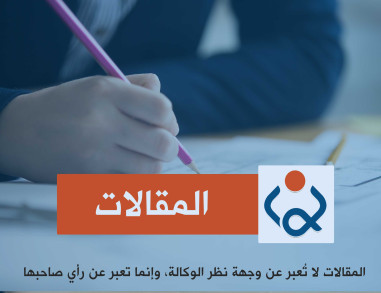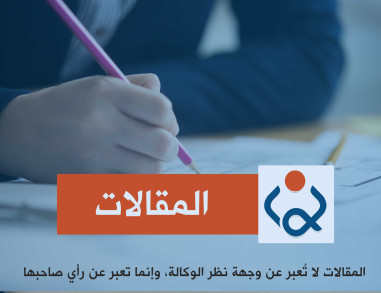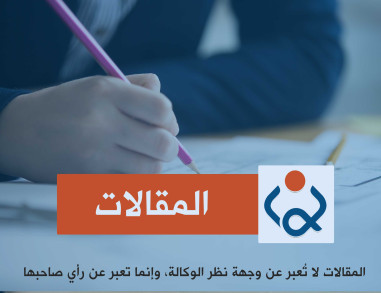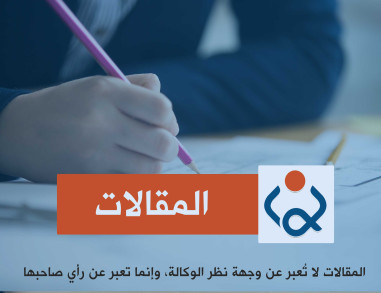- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
الفجوة المعرفية في عصر التحول الرقمي
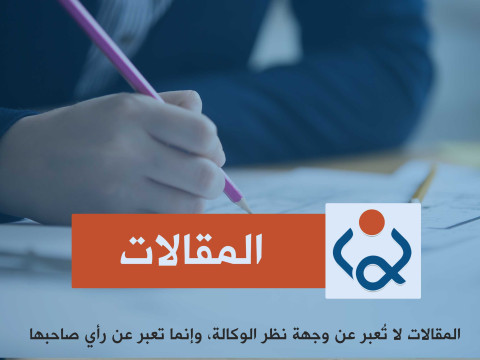
منتصر صباح الحسناوي
في الدرس، قد يمتلك الطالب معلومة بشكلٍ أوسع/ أحدث مما هو موجود في المنهج أو ما يمتلكه الأستاذ، لأنها جزء من معرفة إلكترونية اكتسبها عبر مقطع مرئي أو منصة تعليمية تفاعلية أو حتى محادثة عبر الذكاء الاصطناعي، فتراه تارة يزاحم أستاذه بالمعلومة أو يتمرد بما يمتلكه منها أو يكون غير مكترث للدرس.
هذا المشهد وإن بدا عارضاً، فهو يُعبّر عن تحوّل عميق في بنية العلاقة التعليمية بين الناشئة وأساتذتهم، فالأمر طبيعي أن يتكلم الطالب بلغة أجنبية بلكنتها أفضل من أستاذه، لأنه عمل صداقات عبر النت مع أجانب ومارسوا اللغة بشكلٍ تلقائي بلعبة ما أو منصة جمعتهم، وهكذا بالنسبة لكثير من المعارف والعلوم التي تُكتسب بقصد أو دونه من خلال شبكات التواصل.
الفجوة المعرفية بين الأجيال تجاوزت الافتراض والاستثناء، هي أقرب إلى ظاهرة واقعية تتسع وتستدعي الانتباه، ويمكننا قراءتها من بُعدين متكاملين:
أولاً: تقادم المناهج التعليمية
كثير من المناهج الدراسية المعتمدة في المدارس والجامعات ما زالت تستند إلى مرجعيات نظرية وتطبيقية صيغت في زمن مختلف عن زمن الطلبة “وهنا نتكلم عن التطور الكبير في الزمن القصير”.
فهي تفتقر غالباً إلى الأدوات التفاعلية، وتعتمد أساليب التلقين والتكرار دون أن تواكب التحولات الجذرية في أدوات المعرفة وأساليبها.
نحن إزاء جيل لا يكتفي بالمعلومة المجردة بقدر ما يسعى إلى التفسير والتجريب، جيل يرى التجربة المرئية أكثر إقناعاً من النص المجرد.
ولذلك، حين يُقدّم له درس فيزيائي يفتقر إلى المحاكاة أو نص أدبي دون سياق سمعي وبصري، يفقد الحماسة والانخراط.
ثانياً: تفوق رقمي ومعرفي للطلبة
لم يعد المعلم المصدر الوحيد للمعرفة بوجود الشبكة العنكبوتية، وبتطبيقاتها ومنصاتها التعليمية، التي تمثل مستودعاً ضخماً تتفاعل معه الأجيال الجديدة بمهارة وبديهية. يستطيع الطالب اليوم أن يتعلّم البرمجة أو التصميم أو اللغة الأجنبية من مصادر متعددة لا حصر لها، وأكثر من ذلك، يمكنه تقييم المحتوى ومعرفة الأفضل منه.
يُضاف إلى هذا أن أغلب الطلبة اليوم يمتلكون مهارات رقمية تفوق أحياناً أساتذتهم، ليس فقط في الاستخدام، وإنما في الفهم العميق للبيئة الرقمية ولغتها وثقافتها.
فهم أقدر على التعامل مع الذكاء الاصطناعي والمنصات السحابية وتطبيقات التعليم الذاتي، الأمر الذي يجعل الفجوة بين الطرفين ذات طابع بنيوي، لا معرفي فحسب.
نتائج هذه الفجوة
الفجوة بين الأستاذ وطالبه لا تقف عند حدود الأداء التعليمي، وإنما باتت تؤثر على العلاقة النفسية والرمزية بين الطرفين. من أبرز آثارها:
• تآكل صورة المعلم كمصدر مركزي للمعرفة.
• ضعف انخراط الطالب في البيئة الصفّية التقليدية.
• ارتباك دور المعلم بين التلقين والتوجيه، بين التقدير والتجاوز.
• حالات من التصادم أو النفور غير المعلن تؤثر على الجوّ التربوي العام.
هل انتهى دور المعلم؟
الإجابة هنا لا تتعلق بنعمٍ أو لا.. فالمعلم، إذا ما أصرّ على أداء أدواره بالآليات التقليدية ذاتها دون مراجعة لأدواته وخطابه، سيكون خارج الزمن.
أما إذا أعاد تعريف نفسه گـ مُيسّر للتعلم بدل ان يكون “ناقل معرفة”، فإنه يصبح شريكاً حقيقياً في التجربة التعليمية، وهنا الأمر يستوجب إعادة فلسفة التعليم ذاتها بما يتواكب مع التحول الذي نعيشه.
المعلم الجديد بهذا المعنى هو من يربط بين المعلومة والسياق، بين المعرفة والهوية، بين المعلومة ومصادرها، ويعلّم الطالب كيف يقيّم، لا فقط كيف يحفظ.
حلول واقعية لتجاوز الفجوة
1. تحديث المناهج بصورة دورية، وربطها بمستجدات العلم والحياة الواقعية، ولا سيما الجانب الإلكتروني.
2. تأهيل المعلمين رقمياً، بما لا يقتصر على الاستخدام التقني، وإنما من زاوية التفاعل التربوي داخل المنصات الحديثة.
3. تقديم التعليم كحوار لا كمحاضرة، فالعلاقة الأفقية تخلق ثقة واحتراماً متبادلاً.
4. دعم الابتكار داخل الصفوف، وتشجيع المشاريع والأفكار التي تستثمر مهارات الطلبة الرقمية بدلاً من قمعها.
5. إشراك الطلبة في تصميم المحتوى أو طريقة تقديمه، بما يعزز الإحساس بالملكية المعرفية.
نحن نعيش فقط فجوة زمن تشكّلت فيه المعرفة من مصدر واحد ومنهج واحد، وزمن تفيض فيه المعرفة من كل اتجاه.
أقرأ ايضاً
- الأدلة الرقمية
- تأثير التحول الرقمي على الجريمة المنظمة: التحديات القانونية الواجب مواجهتها
- عصر "التاهو" الثقافي !