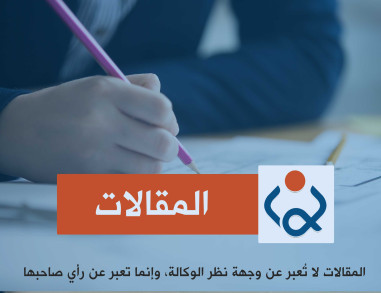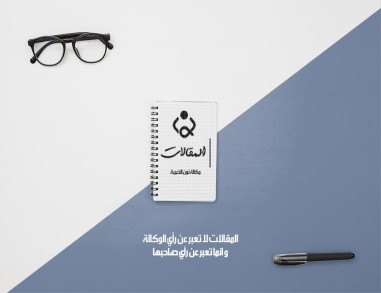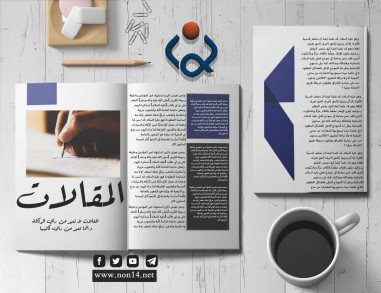- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
مفهوم النزعة المركزية بمواجهة الهويات المحلية
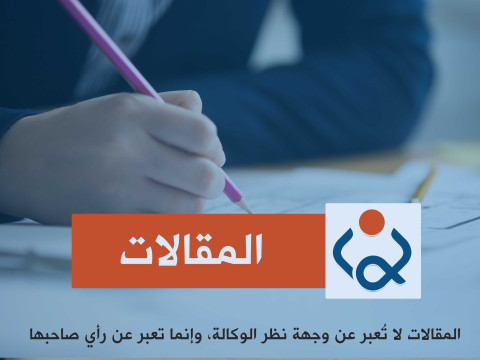
بقلم: منتصر صباح الحسناوي
في كل دولة متعددة المكوّنات يبرز التحدّي الأزلي: كيف تُبنى هوية وطنية جامعة دون أن تُختَزل الهويات الفرعية؟
وكيف يمكن للمركز أن يُصغي للهامش دون أن يخشى تفككاً أو ازدواجاً؟
هذا السؤال يطرحه Hugues Lagrange في كتابه “نكران الثقافات”، منتقداً نزعة بعض الأنظمة الحديثة إلى فرض نموذج معياري للاندماج يقوم على نفي الفوارق الثقافية لا على الاعتراف بها.
من وجهة نظر “لاغرانج” لا تكمن المشكلة في التنوع بحد ذاته بل في السياسات التي تنكر هذا التنوع باسم التوحيد أو العقلنة أو الحياد.
النزعة المركزية – في هذا السياق – تتعدى دورها في التنظيم الإداري الى مشروع رمزي يهيمن على الذاكرة واللغة والرموز، ويُحدّد ما هو جدير بالتمثيل وما هو هامشي.
ولعل الخطورة لا تكمن في الإقصاء الصريح وانما في التطبيع مع فكرة أن الفرد هو وحدة قائمة بذاتها وأنّ خلفياته الثقافية والدينية والاجتماعية قابلة للتجاوز أو الذوبان.
هذه الرؤية يمكن أن تُسهم في قراءة التجربة العراقية من زاوية أكثر توازناً.
فالعراق، بتاريخه الغني وتكوينه السكاني المتعدد لم يكن في نصوصه التأسيسية قائماً على نكران التنوع إذ تضمن الدستور العراقي لعام 2005 الاعتراف صراحةً باللغات، والأديان، والمذاهب، والثقافات المحلية، ونصّ على حمايتها، ودعمها، ومشاركتها في صنع الهوية الوطنية.
لكن الواقع السياسي والاجتماعي في البلاد، لا سيما في العقود الأخيرة التي تَعرّض فيها لهزّات متتالية دفعت الممارسة الفعلية بعيداً عن النصوص. الحروب والأزمات الطائفية ودخول التيارات التكفيرية وصراع الهويات السياسية، كلها ساهمت في تقليص مساحة التعبير الثقافي المتكافئ بين المكوّنات، ليس بقرارٍ مباشر وانما بفعل الضرورة والارتباك والانشغال بالنجاة.
فاقتصر ذكر الرموز المحلية من لهجات وأزياء وأمثال وممارسات في المناسبات، لكنها لا تُدرج في سردية الهوية الوطنية او الواقع إلا من باب التجميل أو التنويع لا بوصفها عناصر مؤسسة.
لا يعني هذا أن العراق يمارس نكراناً منهجياً للثقافات، لكنّه لم يصل بعد إلى مرحلة التمكين الثقافي المتوازن، أي أن تملك كل هوية محلية أدواتها الرمزية داخل الفضاء العام دون الحاجة إلى وساطة أو تخفٍ.
لا تزال بعض اللغات تُدرّس في نطاق محدود وبعض الفنون الشعبية تُعرض كتراث لا كتعبير حيّ وبعض المناسبات الخاصة تُقدَّم كاستثناءات ومع محاولات مركزية لاستثمار التنوع ولا سيما بفتح قنوات ناطقة بلغات غير العربية و الاحتفاء المركزي بمناسبات وطنية جامعة تشمل هذا التنوع الا ان ذلك يحتاج وقت وسبل متعددة على ارض الواقع .
في ضوء ذلك، يمكن الاستفادة من أطروحة لاغرانج بالقول إنّ الانتقال من الاعتراف القانوني إلى التمكين الثقافي يتطلب إصغاءً حقيقياً للهويات المحلية وتفكيكاً ناعماً للنزعة المركزية كحالة تاريخية قابلة للتجاوز.
وهذا التمكين لا يتحقق عبر الحصص أو التوازنات الشكلية، بقدر ما يكون من إعادة تشكيل الهوية الوطنية بطريقة تُعيد كتابة رموزها، وتوسّع خريطتها الرمزية وتجعل من التنوع مصدراً للتماسك لا عامل تهديد.
لا ينبغي للهوية الوطنية أن تُصاغ في قمّة السلطة وانما في عمق المجتمع في سرديات الناس وحكاياتهم، وأمثالهم، وطريقتهم في النظر إلى العالم .
حين يشعر الفلاح الجنوبي والصائغ الإيزيدي والشيخ الكردي والناشط التركماني أن هذه الهوية تمثّلهم دون اضطرارهم للتنازل عن ذواتهم، نكون قد اقتربنا من مفهوم المواطنة دون الإقصاء والإلغاء.
ان ما يدعو إليه لاغرانج في كتابه استبدال المركزية ببناء فضاء مفتوح تتجاور فيه الثقافات دون خوف أو خجل.
وهذا الطموح وإن بدا مثالياً هو السبيل الوحيد لبناء دولة حديثة تستوعب ذاكرتها وتحترم واقعها وتُطلق خيالها نحو المستقبل.
أقرأ ايضاً
- القوامة الزوجية.. مراجعة في المفهوم والسياق ومحاولات الإسقاط
- تشكيل الهويات الإجتماعية
- ما بين مأزق الدراسات العليا المحلية وندرة الابتعاث